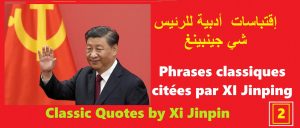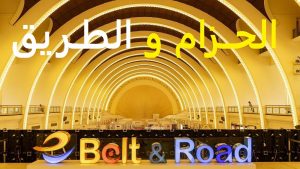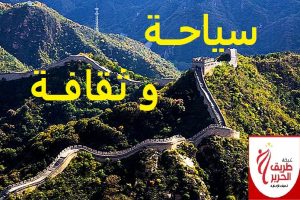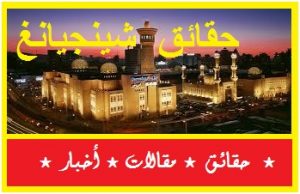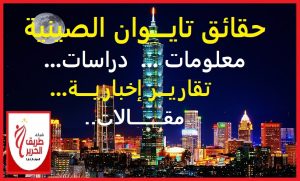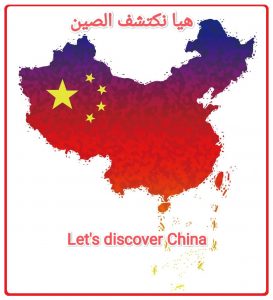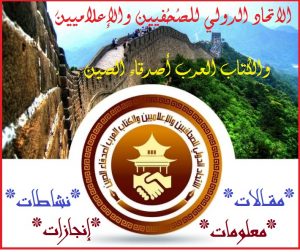الصين وفلسطين: من اتفاق بكين إلى المستقبل المجهول
منذ 5 أشهر في 20/سبتمبر/2025
شبكة طريق الحرير الإخبارية/
الصين وفلسطين: من اتفاق بكين إلى المستقبل المجهول
بقلم : المهندس غسان جابر.
حين تتقاطع الطرق
في لحظة من لحظات التاريخ التي تبدو وكأنها مرسومة بعناية، اجتمع الفلسطينيون في العاصمة الصينية بكين، في قاعة تحمل الطابع الشرقي الهادئ، ليضعوا توقيعهم على اتفاق جديد وُصف بأنه خطوة نحو إنهاء الانقسام المستمر منذ أكثر من سبعة عشر عامًا. كان ذلك في الثالث والعشرين من يوليو عام 2024، عندما خرج إلى العلن “إعلان بكين”، بعد سلسلة من الحوارات الشاقة التي ضمّت أربعة عشر فصيلاً فلسطينياً، من “فتح” إلى “حماس” مروراً بالفصائل الأخرى.
لكن إذا أردنا أن نفهم مغزى إعلان بكين، فلا بد أن نضعه في سياق أوسع، حيث لم يأتِ من فراغ، بل كان امتدادًا لمسار صيني طويل بدأ منذ سنوات، في إطار رؤية أوسع للسياسة الخارجية لبكين، التي لم تعد تكتفي بدور “المتفرج الحكيم” بل صارت تبحث عن موقع “الفاعل الدولي” في قضايا الإقليم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
الصين والقضية الفلسطينية: موقف ثابت برؤية متجددة
منذ عقود، تبنّت الصين خطابًا واضحًا: دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. لم يكن هذا الموقف مجرد شعارات، بل تكرّر في كل المحافل الدولية، من الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن.
لكن الصين لم تكن طرفًا صاخبًا؛ فهي ليست كواشنطن التي تتدخل عسكريًا، ولا كالعواصم الأوروبية التي تربط مواقفها بالمساعدات المشروطة. كانت بكين تطرح نفسها كقوة “محايدة”، ترفع شعار العدالة الدولية وتقدّم دعماً دبلوماسياً وسياسياً مستمرًا، إلى جانب مساعدات إنسانية وتنموية للشعب الفلسطيني.
لقد بدا الأمر وكأن الصين تتعامل مع فلسطين باعتبارها جزءًا من “رمزية كبرى”: قضية عادلة تستحق الدعم، لكنها أيضًا نافذة إلى العالم العربي والإسلامي، وساحة لاختبار صورة الصين كقوة مسؤولة.
من اتفاق 2017 إلى إعلان بكين 2024
في عام 2017، جمعت بكين ممثلين عن “فتح” و”حماس” في محاولة لتقريب وجهات النظر. ورغم أن الاتفاق الذي وُقّع حينها لم يصمد طويلًا، فإنه أرسل إشارة بالغة الأهمية: أن الصين لا تمانع في الدخول إلى واحدة من أعقد الملفات في المنطقة، ملف الانقسام الفلسطيني.
وجاء “إعلان بكين” في 2024 ليؤكد أن التجربة لم تكن عرضًا عابرًا، بل خطوة ضمن استراتيجية صينية أوسع. هذه المرة، لم تقتصر المشاركة على فصيلين رئيسيين، بل شملت 14 فصيلاً، بما يعكس إدراكًا صينيًا أن أي مصالحة فلسطينية حقيقية لا يمكن أن تقتصر على “فتح” و”حماس”، بل لا بد أن تكون شاملة لكل الطيف الفلسطيني.
بنود الإعلان: بين النص والواقع
نص الإعلان على عدة قضايا جوهرية:
توحيد الصف الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
الالتزام بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
تأكيد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وفق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة بقرار من الرئيس الفلسطيني وبالتوافق بين الفصائل.
رفض كل أشكال الوصاية الخارجية على الشعب الفلسطيني.
هذه البنود تبدو في ظاهرها واضحة، لكن القراءة السياسية تكشف أنها تحمل في طياتها معاني أعمق. فالإشارة إلى “حق المقاومة” دون تقييده بوسيلة معينة، يفتح الباب أمام كل أشكال النضال، بما فيها المقاومة المسلحة، وهو أمر ينسجم مع مواقف فصائل مثل حماس والجهاد الإسلامي. وفي الوقت نفسه، يعطي مساحة للرئيس محمود عباس ليواصل طرحه حول “المقاومة الشعبية السلمية”.
هكذا بدا الإعلان كأنه مساحة مشتركة تجمع التناقضات، أو “مظلّة واسعة” تحتها يمكن لكل طرف أن يجد ما يناسبه.
لماذا الصين تحديدًا؟
قد يسأل سائل: لماذا نجحت بكين في جمع الفلسطينيين حيث فشلت عواصم أخرى كالقاهرة والدوحة وصنعاء؟
الجواب يكمن في طبيعة الدور الصيني: فهي قوة كبرى لا تملك تاريخًا استعماريًا في المنطقة، ولا قواعد عسكرية ولا أجندات مرتبطة بالهيمنة. بكين تقدم نفسها كـ”وسيط محايد” لا يبتز أحدًا ولا يفرض شروطًا. في وقت بدا فيه أن كل العواصم التقليدية مرتهنة لحساباتها الخاصة، جاءت بكين لتعرض منصة آمنة، لا أكثر ولا أقل.
إضافة إلى ذلك، فإن الصين بعد نجاحها في رعاية الاتفاق السعودي–الإيراني عام 2023، اكتسبت شرعية جديدة في لعب دور الوسيط الدولي. وبالنسبة للفلسطينيين، فإن وجود قوة دولية غير مرتبطة بالغرب يفتح بابًا لأفق جديد، بعيدًا عن الضغوط المعتادة.
الدعم الصيني المستقبلي: من السياسة إلى التنمية
لكن ماذا بعد؟ هنا يأتي البعد المستقبلي لدور الصين. بكين لا تريد أن تكون مجرد مضيف لجولات الحوار. لديها القدرة، وربما النية، لأن تترجم حضورها إلى دعم عملي.
يمكن للصين أن تساهم في:
1. البنية التحتية والتنمية: من خلال مشاريع طرق وموانئ ومناطق صناعية ضمن مبادرة “الحزام والطريق”.
2. التعليم والصحة: عبر المنح الدراسية، وبناء المستشفيات والمدارس.
3. الاقتصاد: توقيع اتفاقيات تجارية مع السلطة الفلسطينية، وتوفير فرص عمل من خلال الاستثمارات.
4. المجتمع المدني والشباب: دعم المبادرات الشبابية والمؤسسات الأهلية لتعزيز الصمود الفلسطيني.
5. الدبلوماسية الدولية: استخدام موقعها كعضو دائم في مجلس الأمن لدعم القرارات المؤيدة لفلسطين، ومنع تمرير ما يضر بالقضية.
ولعل النموذج الإيراني–السعودي يقدم مثالاً على ما يمكن أن تفعله بكين. إذا استطاعت الصين أن تقرّب بين خصمين تاريخيين في الخليج، فهي قادرة على الأقل أن تمنح الفلسطينيين “مظلّة دولية” تعزز فرص المصالحة.
التحدي الأكبر: الداخل الفلسطيني
ومع ذلك، فإن أي دعم صيني سيظل رهين الإرادة الفلسطينية. فالمشكلة لم تكن يومًا في النصوص والاتفاقيات، بل في التطبيق. فكيف يمكن لحكومة وفاق وطني أن تدير غزة والضفة معًا في ظل مؤسسات مزدوجة وأجهزة أمنية متصارعة واقتصاديات ظل متشابكة؟
الصين تستطيع أن تقدم الدعم، لكن مفتاح النجاح يظل في يد الفلسطينيين أنفسهم. فالخطر الأكبر أن يتحول “إعلان بكين” إلى نسخة جديدة من اتفاقات سابقة، وُقّعت في أجواء احتفالية ثم ذابت مع أول خلاف على التفاصيل.
ما بين الورق والتاريخ
نقول دائمًا: “السياسة لا تُقاس بما يُكتب في البيانات، بل بما يفرضه الواقع على الأرض”. إعلان بكين وثيقة مهمة، لكنه سيظل حبراً على ورق ما لم يتحول إلى واقع يلمسه الفلسطيني في غزة والضفة.
الجديد هذه المرة أن هناك قوة عالمية كبرى مثل الصين دخلت إلى المشهد، لا كمتفرج بل كفاعل. وإذا استطاعت بكين أن تترجم حضورها إلى دعم عملي للمصالحة والتنمية الفلسطينية، فقد يتحول “إعلان بكين” إلى محطة مفصلية في التاريخ الفلسطيني. أما إذا ظل الأمر عند حدود البيانات، فقد يكون مجرد حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الاتفاقات التي وُلدت في العواصم وماتت على أبواب المخيمات.
وبين الأمل والتحدي، تبقى الحقيقة الكبرى أن القضية الفلسطينية ما زالت قادرة على أن تستدعي قوى العالم الكبرى إلى ساحتها، وأن الصين — كما قال أحد الدبلوماسيين العرب — قد تجد في فلسطين “امتحاناً” لقدرتها على أن تكون صانعة للتاريخ، لا مجرد راصدة له.
م. غسان جابر – مهندس و سياسي فلسطيني – قيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية – نائب رئيس لجنة تجار باب الزاوية و البلدة القديمة في الخليل.